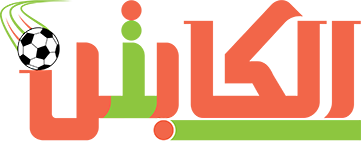المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»
لم تغب فكرة الخلافة عن أى من ورثة محمد على فى الحكم، وإن كانت كتب التاريخ تقول إن أكثر مَن سعى إلى تفعيل مشروعها على الأرض إبراهيم باشا، نجل الوالى الكبير، والذى تبنى مشروعًا طموحًا لبناء إمبراطورية خلافة جديدة تكون قاعدتها مصر، لكن الأوروبيين أحبطوا سعيه وهو يقف بجنوده على باب الأستانة، وظل المشروع عالقًا بعد ذلك فى عصر كل من عباس الأول وسعيد، ثم بدأ يقبع فى زوايا النسيان فى عهد الخديو إسماعيل، ثم توفيق، ثم عباس حلمى الثانى، لكنه طُرح بصورة شكلية بحتة فى عهد السلطان حسين كامل، ثم الملك فؤاد.
كانت فكرة الخلافة تذوب بمرور الوقت وتفتقد وجاهتها، ولم يعد لها من لزوم، خصوصًا بعد الاحتلال الإنجليزى، واستدعاها مصطفى كامل من دواليب الذاكرة المصرية حين بدأ رحلته فى مقاومة الاستعمار الإنجليزى، بالارتكان إلى حق مصر القانونى فى الاستقلال عن إنجلترا بحكم أنها ولاية تابعة للسلطان فى إسطنبول، بدت الحجة غير ذات معنى فى حينها، ولم يكن لها صدى، سواء على المستوى الخارجى الذى كانت تطلق فيه أوروبا على تركيا وسلطانها «دولة الرجل المريض»، أو على المستوى المحلى، حيث استيقظ داخل المصريين الإحساس الوطنى، وترسخ لديهم مفهوم الدولة المستقلة عن كل من السلطنة العثمانية المريضة وعن الإنجليز المحتلين. تحرك مصطفى كامل نحو استدعاء دولة الخلافة كان بدافع من الخديو عباس حلمى الذى كان يريد تحرير مصر من الإنجليز، لكنه لا يملك أدوات واقعية تمكنه من ذلك، وقد رد الإنجليز على سعيه فى هذا الاتجاه بالإطاحة به من سدة الخديوية المصرية بعد رفضه فرض الحماية على مصر مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.
تولى حسين كامل حكم مصر على أسنّة الحراب الإنجليزية، واختار له الإنجليز لقبًا جديدًا يبشر بفصم عُرى الارتباط بين مصر والدولة العثمانية، وهو لقب سلطان، حتى تصبح رأسه برأس السلطان فى الأستانة. منذ ذلك الحين لم يعد للخلافة من جدوى واقعية، سواء على مستوى حكام مصر أو حكام تركيا. وفى سياق استيقاظ الشعور الوطنى لدى المصريين رفض الكثيرون منهم فرض الحماية على مصر، وغضبوا لقيام الإنجليز بخلع «عباس حلمى»، وما أشاعوه بعدها من أنه إذا لم يقبل ولى عهده الأمير حسين كامل الحكم تحت الحماية فسوف يحضرون أميرًا هنديًا ويعينونه واليًا على مصر. وعندما وصل هذا الكلام إلى الأسرة العلوية اجتمع أعضاؤها، ومن بينهم حسين كامل، وتوافقوا على أن يقبل الأخير «الحماية» كشرط «للولاية» حتى لا تتعرض الأسرة للضياع. لم ينس الوطنيون المصريون لـ«كامل» هذا القبول المشين للحماية، وكاد يدفع حياته ثمنًا لهذه الخطوة التى أهان بها نفسه وبلده ومواطنيه، حين قرر عدد من الشباب الوطنيين اغتياله، وتشير كتب التاريخ إلى محاولتين تمتا فى هذا الاتجاه، الأولى شهدها ميدان عابدين عندما تعرضت سيارة السلطان لرصاصات وجهها إليه شاب من المنصورة، لكنها لم تفلح فى إصابته، والثانية فى الإسكندرية عندما أُلقيت قنبلة يدوية على موكب السلطان ولم تنفجر.
قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى بما يقرب من العام توفى السلطان حسين كامل «أكتوبر ١٩١٧»، وجلس على أريكة الحكم السلطان فؤاد الأول، وخلال فترة حكمه سقطت الخلافة العثمانية رسميًا عام ١٩٢٤، وكان من الطبيعى وقتها أن يدرك حكام الأسرة العلوية أن حلمهم التاريخى فى وراثة بنى عثمان بات وهمًا، لكن ذلك لم يحدث، لأن الحلم الفانى كان يتسكع فى رأس الملك فؤاد، واستدعى من الذاكرة استعانة جده الأكبر محمد على بالمشايخ لتمرير ما يريد، فهب عدد منهم فجأة، وعلى رأسهم شيخ الأزهر محمد الأحمدى الظواهرى، ودعوا إلى تنصيب الملك فؤاد خليفة على المسلمين، انطلاقًا من ضرورة وجود شخص واحد يتحدث باسم المسلمين فى أنحاء العالم، كما تعود المسلمون قرونًا طويلة عبر نظام الخلافة. اختلف الرأى العام المصرى حول الأمر، ووجدت الدعوة معارضة قوية من البرلمان، الذى كان يتردد تحت قبته صدى أفكار ثورة ١٩١٩ فى الدولة الوطنية المدنية الحديثة المؤمنة بأن الدين لله والوطن للجميع، وظهر تيار موازٍ يعارض الفكرة بين بعض مشايخ الأزهر، على رأسه الشيخ على عبدالرازق.
ألّف الشيخ على عبدالرازق كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، وخلص فيه إلى أن الخلافة لا تعد ركنًا من أركان الحكم فى الإسلام، وأشار إلى عدة تعريفات للخلافة، منها التعريف الذى يذهب إلى أنها تعنى «رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى، صلى الله عليه وسلم»، كما أورد تعريف ابن خلدون الذى يقرر أن الخلافة هى «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به». والخلط بين مفهوم الدين والدولة فى هذه التعريفات واضح لا لبس فيه، والسر فى ذلك أن الخليفة ينظر إليه على أنه نائب عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رغم البون الشاسع الذى يفصل ما بين النبى المعصوم الذى يأتيه الخبر من السماء، وأى شخص آخر يجتهد بعقله ونظره فى الأمور والنصوص فيخطئ ويصيب. وربما كان السر فى هذه التسمية يعود إلى العبارة العُمَرية الشهيرة التى قالها ابن الخطاب فى اجتماع السقيفة الشهيرة فى معرض دفاعه عن حق أبى بكر الصديق فى الخلافة: «رضيه رسول الله خليفة له فى دينه أفلا نرضاه خليفة له فى دنياه».
موقع الدين فى الحياة السياسية للأسرة العلوية تم تحديده بدقة على يد محمد على، الرجل الذى تبنى رؤية قدرية فى الجلوس على كرسى الحكم تذهب إلى أن المُلك مُلك الله يؤتيه من يشاء من عباده، وأن الجالس على العرش يتوجب عليه أن يعتمد رؤية عملية مصالحية فى النظر إلى الدين، فيجرى معه حيث تجرى مصالحه، وينحيه جانبًا حين تكون فائدته فى ذلك، وقد ظلت هذه الأسرة متعلقة بحلم تحول حاكم مصر إلى خليفة يبسط نفوذه على كل الدول الإسلامية، لكن حلمها تبدد لأسباب عديدة خارجية وداخلية.. وبزوال هذه الأسرة دخلت العلاقة بين الدين والسياسة فى مصر إلى مرحلة أخرى جديدة، بدت فيها السلطة متشربة بالكثير من المعادلات الموروثة عن الآباء والأجداد من الحكام السابقين.